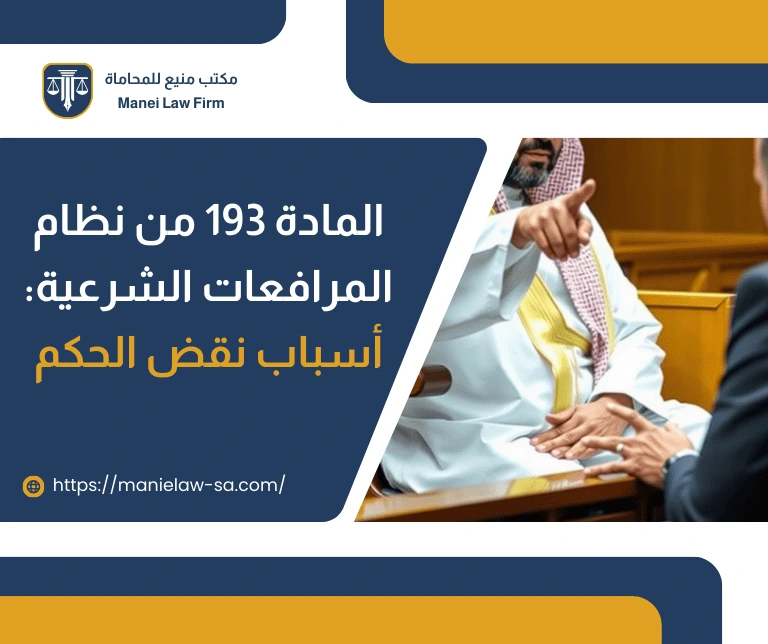المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية هي التي تُحدد الحالات الأربعة التي يجوز فيها تقديم طلب نقض على الأحكام الصادرة أو المؤيدة من محاكم الاستئناف، وفي غير تلك الحالات لن يُقبَل طلب النقض ولن يُنظَر فيه، وفيما يلي نبين النص النظامي، وشرح لكل حالة.
المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية
تنص على أنه: “للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2- صدور الحكم من محكمة غير مُشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه نظامًا. 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم“.
شرح المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية
إن الدعوى حينما تُنظَر سواء أمام الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية فالاثنين ينظرن للقضية بأكملها وبكامل وقائعها وظروفها وأدلتها، ولكن أمام المحكمة العليا فالوضع مختلف بعض الشيء؛ إذ يقتصر نظرها في الطعن بالنقض على التأكد من صحة الحكم من الناحية النظامية والشرعية وسلامة الواقعة من حيث التكييف والوصف، ولكن لا يتم بحث أي شيء من الوقائع أمام المحكمة العليا، ويُعبَر عنها في هذا الشأن بـ”محكمة النظام“.
ولقد جاءت المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية لتُحدد الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب نقض للمحكمة العليا، وبالتالي؛ تنظره المحكمة وتفصل فيه، وإن رأت وجاهة من الطعن؛ فإنها تنقض الحكم وتعيده لمحكمة الاستئناف لتفصل في القضية من قِبَل دائرة جديدة، وتتمثل تلك الحالات في أربعة أسباب محددين على سبيل الحصر، وفيما يلي نبينهم:
أسباب نقض الحكم
إن أسباب نقض الحكم ممثلة في أربعة، أولهما مخالفة النظام والشريعة، وثانيهما الخطأ في تشكيل المحكمة، وثالثهما مخالفة الاختصاص، والرابع هو الخطأ في وصف الواقعة أو تكييفها، ونتناولهم بالشرح في الآتي:

السبب الأول: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة
وفي تلك الحالة يجب أن يكون الحكم محل الطعن بالنقض لا يخالف أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة، كما يجب ألا يكون مخالفًا لأي نص نظامي وجوبي يتضمن قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولا يقتصر الأمر على مجرد المخالفة، بل يشمل أيضًا الخطأ في تفسير النص النظامي، أو تأويله بما لم يصح.
كما أن المخالفة هنا لا تقتصر على أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، بل يمتد ليشمل أيضًا المبادئ القضائية التي تصدرها المحكمة العليا، وهذا ما قررته المادة (40) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام: “إذا كان محل الاعتراض مخالفة لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُد اعتراضًا لمخالفة النظام وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام“.
مثال للحالة: إن المادة (17) من نظام الإثبات تنص على أن: “الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه“، وبالتالي؛ إذا ما حصل وصدر الحكم ضد أحد الأشخاص بناءً على إقرار صادر عن غيره، فيكون هذا الحكم مخالفًا لأحكام النظام في المادة النظامية المشار إليها.
تعرف على/ الإقرار القضائي (تجزئته – الرجوع فيه)
السبب الثاني: صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا
إذ إن للمحاكم تشكيلات يُقررها النظام، ويتعين على القضاة الالتزام بها عند النظر في الدعاوى المعروضة أمامهم، وبالتالي؛ إذا خالفت إحدى الدوائر ذلك فيكون الحكم الصادر عنها باطلًا، ويتعين نقضه.
ومثال ذلك؛ لو أن النظام يشترط لنظر القضية أن تُشكَّل الدائرة من ثلاثة قضاة أو خمسة قضاة، ولكن الحاصل أنها نُظِرَت من قاضي واحد أو اثنين؛ فهذا يعد خطأً في الحكم ويكون مدخلًا لنقض الحكم.
السبب الثالث: صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة
إن مسألة الاختصاص من أهم المسائل النظامية التي يتوقف عليها صحة الحكم القضائي الصادر، ونخص بالذكر هنا كل من الاختصاص النوعي، والاختصاص الدولي، والاختصاص الولائي، والموضوع باختصار يتمثل في أن النظام يُحدد نوع القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم، فعلى سبيل المثال: منازعات عقد العمل، والعلاقات العمالية؛ تدخل في اختصاص المحاكم العمالية، وبالتالي؛ إذا نُظِرَت دعوى عمالية أمام محكمة تجارية مثلًا، فهذا يعتبر خطأ في الاختصاص النوعي، ويكون الحكم متعينًا نقضه حسب الحالة محل الشرح.
السبب الرابع: الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم
هذه من أصعب الحالات كتابةً ودراسةً للأحكام وطلبات النقض، وتكمُن الصعوبة في أن المحكمة العليا لا تنظر وقائع، بمعنى أبسط هي لا يهمها الخصوم في الدعوى بأي حال من الأحوال، وإنما ينصب همها الأساسي على ضمان عدم وجود أخطاء في الحكم.
ومن ضمن هذه الأخطاء هو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم، وهنا يتبادر للذهن تساؤل كيف يمكن بيان الخطأ في الواقعة دون التطرق للوقائع نفسها التي لا تنظرها المحكمة العليا؟!
الإجابة ببساطة هي أن طلب النقض يجب أن يوضح الأخطاء نفسها، فعلى سبيل المثال؛ لو أن العقد بين الطرفين في الدعوى عبارة عن تسليم مال من أحد الطرفين، في مقابل أن الطرف الآخر سيقوم بالاستثمار في هذا المال، فالتكييف الصحيح لهذا العقد هو أنه “شراكة مضاربة“، وبالتالي؛ إذا انتهى الحكم -محل الطعن- إلى اعتبار العقد من قبيل شراكة العنان مثلًا، فهنا نكون أمام “خطأ في التكييف”.
وأيضًا في مسألة الخطأ في وصف الواقعة وصفًا غير سليمٍ، يتم التطرق وإبراز خطأ الوصف نفسه دون الإسهاب في الوقائع نفسها، فعلى سبيل المثال: لو أن الحكم -محل الطعن- انتهى إلى ثبوت تناقض المحكوم ضده في الدعوى، بالتأسيس على أقواله المدونة في الضبوط، ولكن الحقيقة أنه لا يوجد تناقض ولا شيء، فهنا يتم بيان الخطأ في وصف الأقوال بأنها متناقضة على خلاف الحقيقة.
وأخيرًا، في ختام مقالنا نؤكد على أن مرحلة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أهم مراحل التقاضي؛ لكونها الخطوة والفرصة الأخيرة للطعن في الحكم، ولا نخفيكم أن كتابة طلب النقض في حد ذاته ليس بالأمر السهل وإنما يحتاج لمتخصص ومتمرس في مهنة المحاماة لسنوات عدة، ويسعدنا في مكتب منيع للمحاماة أن نضع بين أيديكم خبراتنا في هذا المجال، ونتشرف بتواصلكم معنا لنساعدكم في هذا الشأن.
اقرأ عن/ طريقة الاعتراض على الحكم